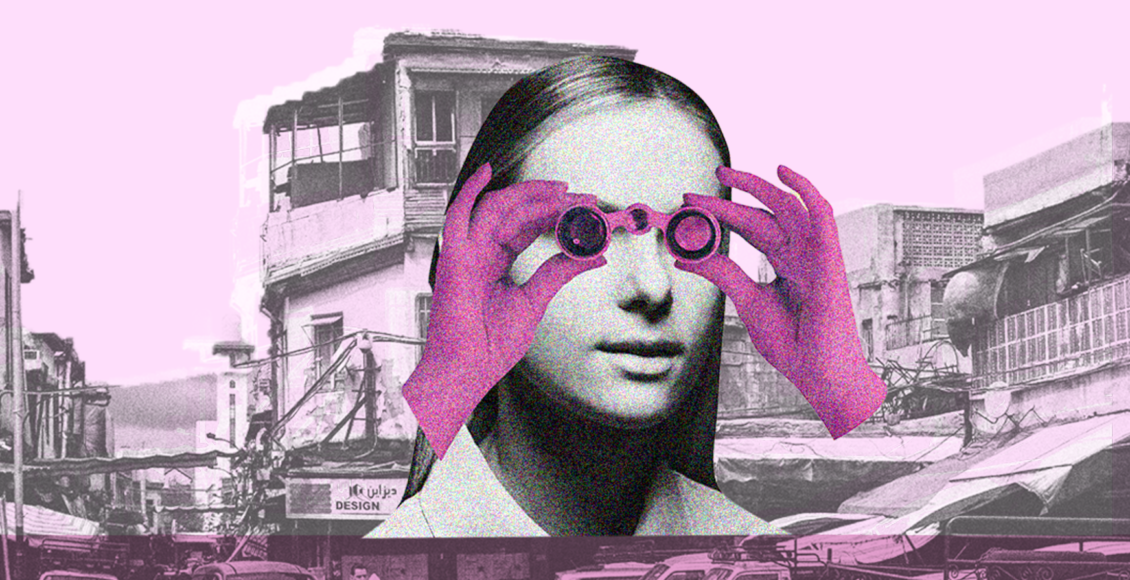
سوريا.. النساء بين الحرية والثورة واغتصاب الشريك
في سوريا وخارجها، أعمل جاهدة خلال السنوات الماضية على تشكيل هوية أوسع من اختزالها بدافع، وأكبر من حصيلة نجاة متكررة لامرأة ولدت فلسطينية، سوريّة، من عائلة يسارية “تحررية”. ولكنني دومًا أعود لأنطلق من هذه الأعمدة الأربعة، حين أصيغ تجربتي بالاستشفاء من الانتهاك الجنسي واقترانه بالحرب في سوريا.
لا تحمل – بالضرورة- الصياغة تعداد النزاعات والمجازر التي حدثت خلال أكثر من عشر سنوات. بل شكل الحياة اليومية الموازية لها والتي تخضع أولًا للدور الجندري، وثانيًا لأعراف العنف والحرب.
حين شرعت بكتابة هذا النص، كنت مدفوعة بالاستشفاء من الاغتصاب الذي تعرضت له في مراهقتي، أي في السنة الأولى من الثورة.
أكتب لجميع النساء اللواتي استغرقن سنوات عديدة لتجاوز الوصمة الاجتماعية الملتصقة بتجاربهن الجنسية. أكتب للواتي احتجن سنوات طوال لتصنيف هذه التجارب، وتعريف الاغتصاب من الشريك على أنه جريمة نجين منها.
كان المغتصب صديقًا لعائلتي، اكتسب ثقتها لكونه معتقلًا سابقًا في سبيل الحرية والعدالة. بعد المواجهة الأولى لألم الاغتصاب المتزامن مع الحرب، بدأت أدرك فداحة التجارب التي استحوذت على جسدي وانتهكته. كل تلك الانتهاكات كانت تحت مسميّاتٍ عدّة مثل شريك الحرية والجسد، النضال والتحرر. هذا العبث أثبت بالتجربة، معي ومع كثيرات غيري، أنه مجرد اصطلاح معزول تمامًا عمّا يدور في حيواتنا الشخصية.
View this post on Instagram
لنفسي وللأخريات.. لن نكون وحيدات طالما لدينا بعضنا البعض
أكتب لجميع النساء اللواتي استغرقن سنوات عديدة لتجاوز الوصمة الاجتماعية الملتصقة بتجاربهن الجنسية. أكتب للواتي احتجن سنوات طوال لتصنيف هذه التجارب، وتعريف الاغتصاب من الشريك على أنه جريمة نجين منها.
لا شكّ أن هذه التجارب فيها من التعقيد الكثير، لكنّ ما يزيدها تعقيداً، هي الخلفيات الاجتماعية اليسارية التي أتت منها بعض النساء وتم التعامل معها على أنها “أفضلية” و”امتيازًا”. حيث لا تضطر النساء المنحدرات منهاإلى خوض حروب ضارية مع أُسرهن لممارسة حيواتهن الجنسية خلف أبواب محكمة الإغلاق، كما يفرض المنطق الأبوي العام.
أكتب كي أستطيع الفصل والتمييز بين التجارب الشخصية التي حاربت لانتزاع حقي بخوضها، وتلك التي فُرضَت عليّ، فتوهمت أنني خضتها بمحض إرادتي.
أكتب خصيصًا للنساء اللواتي يعتقدن أنهن بعيدات عن قمع هذه المنظومة، وأن ظلمها لم يقع عليهن بالشكل “الكافي” يومًا، فلا حاجة لهن للنجاة من سيطرتها. أنا واحدة منهن.
النساء داخل العائلات اليسارية والثورة على المجتمع والدولة
مثل غالبية النساء داخل المجتمعات الأبوية في سوريا، تعلمتُ أن كل تجربة جنسية هي إما واجب نؤديه تلبية لرغبات شريك ما، وإما عار يجب إخفاؤه إلى حين الحصول على الشريك “الأبدي” المناسب.
كنتُ من النساء اللواتي يُصنّفن متحررات أو محظوظات، لأنهن ولدن وتربين ضمن عائلات آمنت بالقيم السياسية اليسارية. عائلات لم تعرف العيش إلا تحت وطأة نظام البعث القمعي والذكوري.
حاولت هذه العائلات أن تنتفض اجتماعيًا على منظومة استبدادية متشعبة. وفّرت هامشًا أوسع للحرية الجسدية للفتيات والنساء داخلها، مقابل تحديد وخفض صلاحيات الرجال. بمعنى آخر، حاولت هذه العائلات خلق نمط “ثوري” يخالف العرف السائد الذي فرضه النظام عبر تكريس النمطية الجندرية وتقييد حريات الفتيات والنساء الجسدية والجنسية، ووضعها في قالب يتحكم فيه رجال العائلة.
نشأتي في إحدى هذه العائلات لم تضطرني للمحاربة لأحظى بالقبلة الأولى من شاب صغير واعدته خلال مراهقتي. لم أضطر لإخفاء مواعدتي له، ولكن كان عليّ إضافة “تزيينات” لهذه العلاقة لمنحها شرعية أمام عائلتي. الاتجاه الثوري والطموح العلمي المشترك والاهتمام الأدبي الثقافي المميز، كانوا على رأس القائمة.
في ظلّ القمع الوحشي الممنهج لأجساد النساء، تُقنع النساء اللواتي حظين بمراهقة أو شباب أقرب للتحرر أن ما حظين به من حريات كافٍ، بل مُفرط أحيانًا.
استمرت هذه “التزيينات” أو الإضافات بالتطور خلال السنوات اللاحقة للمراهقة. إذ أخذت أشكالًا أخرى ترتبط بمعايير الشرعية المحددة من العائلة وتندرج تحت الاهتمام السياسي والانتماء الوطني، والأخلاق الإنسانية الوجدانية والقيم العليا الثورية. تعقّدت الطبقات والتصنيفات مع التقدم في العمر.
لحُسن الحظ، لم تأخذ يومًا شكل الإلزام لتحديد الرؤية لحياة مشتركة لاحقًا. أعني أنه لم يُفرض عليّ مفهوم الشريك الواحد الأبدي، لكنها أخذت شكلًا يضمن أنه لن يؤثر على وجود شريك لاحق. كان المعيار هو اختيار شريك يحفظ الخصوصية والأسرار في مجتمع يصم النساء بجنسانياتهن وسلوكياتهن.
في ظلّ القمع الوحشي الممنهج لأجساد النساء، تُقنع النساء اللواتي حظين بمراهقة أو شباب أقرب للتحرر أن ما حظين به من حريات كافٍ، بل مُفرط أحيانًا. تجتمع العوامل لتشكّل تجارب عشوائية لا تنتمي للمجتمع المتشدد والمحافظ، ولا للمجتمع الحرّ الليبرالي، أو حتى تقترب من الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتعن بها. فخُلقت تجارب مبتورة، تشدّها التيارات المختلفة من جانبي عجلة تدور فوق أجساد النساء.
خلال تجربتي باكتشاف المجتمع الأكبر في مدينتي، التقيت عددًا من الشركاء في مراحل مختلفة. وفي كل تجربة، كنت اكتشف مجتمعًا كاملًا من خلفها لم أعلم عنه شيئًا سوى حكايات روتها عائلتي لتمايز نفسها بأفضلية الشجاعة في مواجهة تقاليدها وعاداتها. أثناءها، بدأت أدرك الاختلاف البنيوي في تعريف العلاقات الحميمية بيني وبين شركائي، والخلفية الاجتماعية والتربوية التي تقف خلفها، داخل حيز جغرافي صغير نسبياً.
كان المعيار الأول لاختيار شريكي هو رفضه الوصم الاجتماعي للتجارب الجنسية. وخلال مراحل شبابي الأولى، ارتبط هذا المعيار بالحرية التي يعتمدها الشاب ضمن حياته الشخصية. أولاً، ابتعاده عن التعريف الديني للجنس الرضائي ووصفه بـ “الزنا”. وثانيًا، اعتماده نمط حياة أكثر حرية وثوريّة على المجتمع. ربطتُ هذه القيم بشكلها الظاهري المتجسد في المعرفة الأدبية والذوق الموسيقي، والاطلاع السينمائي والأفكار التحررية العامة.
خلال السنوات اللاحقة تطور المعيار – أيضًا وفق تعريف العائلات المتحررة اليسارية. وانعكس ذلك على الاتجاه السياسي والقيم التحرريّة، والسلوك المرافق للقناعة السياسية والقراءات الثورية والأدبية التي تناقش قيمًا اجتمعنا عليها في الثورة.
سوريا.. تجارب جنسية خلف أبواب مغلقة
رغم ذلك، اختبرت، مثل العديد من النساء السوريات، التجارب الجنسية خلف أبواب محكمة الإغلاق. عايشتُ التوتر الدائم لاكتشاف أمر التواجد مع شاب بمفردنا، ليس من عائلة تتبنى مفاهيمًا تحررية، ولكن من المجتمع الأكبر.
كانت عائلتي تعيش ضمن مجتمع أبوي حال دون خلق تجربة تحررية حقيقية. على الرغم من قناعاتها، لزمت عائلتي التبرير وخلق الأعذار والمواربة على الحقائق. كل هذا جعل الجيران القاطنين في المبنى والبقال قرب المدخل، وحتى المارة في الشارع، جزءًا من العناصر التي تتحكم بالقرارات التي اتخذها مع جسدي.
ليس غريبًا أن الهاجس الأول، لي ولمعظم الشابات والشباب، كان أن يستدعي الجيران القوى الأمنية لاعتقالنا بتهمة “الدعارة والزنا”.
أذكر أنني زرت صديقي في منزله، فاستدعته إحدى الجارات لتخبره أن ابنتها رأتني أدخل المنزل، وأنها قلقة عليها لأنها رأت هذا الموقف “المفتّح” للعين والمؤذي “للأخلاق”. ثم هددت بطلب الشرطة في المرة القادمة، إن علمت أنني ما زلت أزوره. لم أفهم يومها ما هي الشرعية الممارسة من قبلها، لكنني انصعت.
أصبح لقاؤنا المحفوف بالمخاطر -من الخارج- محصوراً خلال الساعات المتأخرة من الليل أو الأولى من الصباح الباكر.
اختياري لهذه الساعات أتى من المرونة التي يمكن أن تتيحها عائلة متحررة لمواعيد المغادرة والعودة إلى المنزل.
كان العامل الأول في تحديد هذه الساعات هو غياب أعين الجيران. أي أنهن/م مَن تحكّمن/وا في ساعات لقائي بصديقي. لم أخف أن يصل الخبر إلى أهلي – أنني أزور صديقي في منزله.
اخترنا دائماً الذهاب إلى منزله، لأن ممارسة الجنس في منزل العائلة “عيب”. حتى بالنسبة لعائلة متحررة، تعتبر ممارسة الجنس في منزل الأسرة تعديًا على المقدسات العائلية.
ما أخافني حقاً هو أن أكون السبب في انكسار أبي أمام الضابط الأمني الشامت، إذا ما تم استدعاؤه للمخفر، لأن ابنته قد ضُبطت بـ “واقعة زنا”. حينها أدركت، أيضاً، أن حتى الأبواب المغلقة لن تحميني من العنف.
وعلى الجهة المقابلة من الباب المغلق، لم نختبر، نحن الفتيات والنساء المنحدرات من عائلات متحررة، تجربة واحدة لقبلة صغيرة أو عناق لطيف في الشارع دون التلفت في جميع الاتجاهات، والاضطرار لتبرير شكل العلاقة التي تجمعنا بالشخص. كنّا أحيانًا نختلق إحداها ضمن هامش تسمح به العادات. وهو ما جعلني “ابنة عم” معظم الاصدقاء الشباب الذين زرتهم في منازلهم.
كانت هذه الحجة يستخدمها الشباب والشابات اللواتي اختارن/وا اللقاء في المنازل، ولو بغرض شرب القهوة. بناء على هذه الحجة المتكررة، أصبح لديّ العديد من” بنات العم”. بفعل النسب والعلاقة المتعددة مع أصدقائنا الشباب المشتركين، أصبحنا جميعنا أولاد وبنات عم أمام الجيران والمجتمع المحيط.
شعرتُ بالمفاجأة، عندما علمت أن والدتي تستخدم عادةً الحجة ذاتها، لتبرير زيارة أصدقائي الشباب إلى منزلنا أمام الجارات. أصبح لديّ عائلة كبيرة بفعل العلاقة المتعددة. أما بالنسبة للمجتمع المحيط بنا، يعتبرن/ون أننا نسيج واحد لا يتزحزح عن صدره، حين يضطرن/ون لمواجهة وتبرير وجودنا أمام الفتيات والنساء من عائلتهن/م. يقدموننا نموذجًا معيبًا وشاذًا، لكنه “موجود” في المجتمع السوري.
المدينة والإيمان بالخلاص في الثورة
عقب الثورة السورية، نزح عدد مهول إلى المدينة الساحلية السورية، من اللواتي/الذين خسرن/وا منازلهن/م في قصف النظام، بسبب ثورتهن/م على الظلم والقمع.
من مختلف المدن والمجتمعات السورية، ازداد عدد القاطنين/ات في كل حيٍّ حتى أوشك على الانفجار. ظننت للوهلة الأولى أن القيود قد حُلّت عن تواجدي في منزل صديق شاب لي. ظننت أن العين الممعنة في شؤون الآخريات/ين ستغيب عن المبنى أو المباني المحيطة، أو على الأقل ستعترف بالحرية قيمة لا يمكن المساس بها. ولكن الأعين صارت أكثر إمعانًا وتركيزًا، ولم نُنسَ في زحام المدنية ولا حتى تم تجاهلنا.
هناك وصمة محيطة بالمدن الساحلية، لكونها تضم المكوّن الطائفي المغاير للمكونات الدينية الأخرى القاطنة في غالبية المدن السورية.
يوصم سكان المدن الساحلية بالاستهتار بأجساد نساء العائلة، بوصف الأخيرات ممتلكات خاصة. هذا بالإضافة إلى الانغلاق وانقطاع قنوات التواصل والمعرفة بين هذه المكونات جميعها.
بشكلٍ ما، أصبحت التجارب الشخصية لقلة من النساء، اللواتي لديهن بعض الحرية في التعامل مع أجسادهن ضمن المدينة، سلاحاً لوصم المجتمع الأكبر داخل المدينة.
المدينة نفسها لم تعترف بتجاربنا يوماً سوى أنها دخيلة على قيمها وعاداتها الذكورية.
مع اعتبار أجساد النساء “أسلحة” في النزاع السوري، سواء باستخدام الاغتصاب الممنهج في مراكز الاعتقال أو التهديد به على نطاق واسع لإخلاء المدن المعارضة، تكوّنت طبقات قامعة أكثر قسوة على النساء.
اعتقدتُ أن الحرب المروعة التي يمر بها مجتمع انتفض من أجل الحرية والعدالة سوف تفضي لإعادة ترتيب الأولويات لأفراده. ستكون القيم التي خسرن/وا أرواحاً ومنازلاً وحياة كاملة من أجلها، قيماً عُليا لا يجوز المساس بها. ربما سيحاربن/ون من أجلها في كل زمان ومكان.
أجساد النساء في شِباك المدينة
واقعيًا، لم تكن أجساد النساء ضمن معادلة “ثورة الحرية”. فالنظام السياسي القمعي الأبوي قد خلق طبقات متشابكة من القمع الذي يستهجف الفئات الظاكثر هشاشة. أعاد ضحايا النظام توجيه العنف الذي تلقّوه والغضب الذي شعروا به ضد فئات اعتقدوا أنه بالإمكان حكمها وقمعها.
في المجتمعات الأبوية، تترأس النساء قائمة تلك الفئات، بدايةً من أجسادهن ووصولًا إلى حدود ما يمكنهن حتى التفكير به. على وجه الخصوص، نساء أتين من المناطق المنكوبة إلى المناطق “الموصومة” بأنها مؤيدة للنظام القمعي وتشكّل قاعدته الشعبية.
ومع اعتبار أجساد النساء “أسلحة” في النزاع السوري، سواء باستخدام الاغتصاب الممنهج في مراكز الاعتقال أو التهديد به على نطاق واسع لإخلاء المدن المعارضة، تكوّنت طبقات قامعة أكثر قسوة على النساء.
تطورت القيود التي خلقها النظام السياسي والعسكري الأبوي من منح الشرعية للتحكم بأجساد النساء وتعزيزها بالقوانين والسياسات، إلى خلق حاجة لمراقبة هذه الأجساد عن كثبٍ وصونها من “هتكٍ” قد تتعرض له تجنبًا لهزيمة مضاعفة تطال رجال عائلاتهن. خلق ذلك قيودًا إضافية على النساء وتحركاتهن وحياتهن اليومية.
قام الرجال الهاربون من الحرب بتدوير عجلة اللوم والوصم المرتبطة بالمدن المعارضة، والهزيمة والقتل في مدينة تعتبر موالية للنظام، وممارسة هذا العنف تجاه النساء اللواتي على اختلاف خلفياتهن – إن كنّ من قاطنات المدينة أو نازحات – هن الأكثر هشاشة.
كما مارست النازحات رفضًا عنيفًا لحياة النساء الأخريات في المجتمع “المضيف” باعتبارهن خطرًا وجوديًا وثقافيًا سيلحق النازحات بعد أن نجين من خطر الموت. وهو ما لا ألومهن عليه على أية حال.
بهذه الصورة والعلاقات المتشابكة، تبدو المدنية وعنفها لوحة واحدة من الاضطهاد المكرَّس لممارسة الدفاع الذاتي، أمام الوحش العنيف المتمثّل بالنظام القمعي والمجرم الذي يكتسح المدينة.
في محاولة لكسر قيود السياسة والعسكر على أفكارنا وأجسادنا، وضعنا، نحن الشابات اليساريات الثوريات، معايير أخرى لاختيار الشركاء بناء على مواقفنا الرافضة للنظام القمعي. في حين رأينا فيهم الشركاء لخلق واقع ثوري على الصعيدين السياسي والشخصي، سرعان ما احتكر الرجال منهم هذه المفاهيم.
أعاد “شركاء الثورة والحلم” صياغة هذه المفاهيم بما يحصر وجود النساء بأنهن شريكات “داعمات” حين يشتد القمع السياسي. أسقطت هذه المفاهيم أجساد النساء وذواتهن من المعادلة، ووضعتها في حقل “الحاجة لها” لإنقاذ الرجال من الشعور بالعجز الكليّ عن تحقيق نصر ثوري واقعي.
شريك الحرب والثورة.. مغتصِب
في خضم الحرب والفوضى والخطر، نلجأ إلى الحب والحميمية حين نخاف. تكون العلاقات الجنسية أحد أوسع المساحات لاختبار التعرّي العاطفي والنفسي قبل الجسدي.
باتت كلمة “لا” أكثر صعوبة أمام شريك الخطر والثورة الذي شاركني بداية المعاناة مع هذا القمع والتَوق للتحرر منه. من الصعب جدًّا المواجهة على جبهتين: إحداها في الخارج، والأخرى ملاصقة لجسدي.
ولكونها مغلّفَة بطبقات أكثر حساسية، تعكس هذه العلاقات الحاجة للحميمية والتعري النفسي أمام شخص يشاركنا الهواجس والخوف والتوق إلى الحرية. في هذه الحالة من انعدام اليقين، يصبح الجسد واقعًا فيزيائيًا وحيدًا يُمكن التعامل معه على أنه يقين الوجود.
حين يصبح اليقين متمثّلًا بوجودي أنا والشريك، تصير العلاقة خاصة وتتسمّ بالندية. ترتبط خصوصية العلاقة بسرية اعترافنا بحقنا في الثورة على النظام والمجتمع على حدٍ سواء. وفي حين كانت الندية فكريّة تناقش سبل الحرية وجذور القمع والعنف، سقط من المعادلة جسدي، أول تعبيراتي عن ذاتي ضمن علاقة ثنائية جمعها أولاً حلمٌ جمعيٌ لبلاد كاملة.
خلال هذه التجربة، لم أستطع تمييز العنف الذي يمارسه الشريك، المعنَّف بدوره من الدولة ذاتها، أو الإسقاط الذكوري على جسدي ومحاولة امتلاكه كبديل عن ساحة الاحتجاج. كانت هذه الممارسات الجنسية الإجبارية، والمؤلمة، انتهاكًا لجسدي وذاتي.
فكما غلّفتني قيود تمنعني من قول “لا” علنًا للقمع الممنهج من المجتمع خلال نشأتي، باتت كلمة “لا” أكثر صعوبة أمام شريك الخطر والثورة الذي شاركني بداية المعاناة مع هذا القمع والتَوق للتحرر منه. من الصعب جدًّا المواجهة على جبهتين: إحداها في الخارج، والأخرى ملاصقة لجسدي.
في الفعل الجنسي المكروه، تتوارد أفكار تبرر و”تُلطِّف” اغتصاب الشريك، باعتباره غضبًا أو عجزًا يتعامل معه باستخدام جسدي. حينها، صدّقتُ أنه ليس المجرم، بل النظام الذي شكلنا على هذه الهيئة. فقد تعلمتُ أن أجساد النساء، حتى ضمن العائلات المتحررة، هي مساحات لاحتواء ودعم الشريك المُحبَط سياسيًا. فالمرأة تدعم بجسدها شريكها المُتعَب، حتى يستعيد بطولته في ساحات الثورة. هكذا قيل لنا.
في هذه الأثناء، يصعُب تصنيف تجاربنا الجسدية خارج كونها علاقة مع الشريك الذي نطمح لمستقبل يجمعنا، أو أنها تجربة عابرة غير مؤذية نمارسها بين الحين للآخر. فالجسد، كما الغضب، يحتاج متنفسًا، نجده مع أفراد نثق بالغضب أمامهن/م من النظام ورجاله، في بلاد يكفي أن تعترينا نوبة غضب واحدة للاحتجاج على دور البنزين أو في تأخر المعاملات الرسمية في مؤسسة حكوميّة حتى نخسر حياتنا بأفضل الأحوال.
يصبح الغضب من أفعال “رجال الثورة التحرريين” هامشيًّا أمام فظائع وحشية يرتكبها رجال النظام. ويكون ذِكر الألم الشخصي الناتج عن عنف الشريك مُعيبًا، أمام انكسار وفواجع آلاف العائلات في الحرب.
وقتئذ، يُستبدل الحديث الثنائي بين شريكين ارتكب أحدهما جرمًا بحق الآخر، بحديث عن الجرائم المفزعة على صعيد الدولة.
تضيق المساحات والخيارات الشخصيّة أكثر، حين ترتبط الحرية والغضب والجسد معًا. وفي حيز محدود للغاية، يتم اختيار شركاء لمجرد أنهم انتفضوا على التصنيفات الاجتماعية. وفي اللحظات الحميمية المُكرهة التي مررت بها، تراكمت الأفكار لتخلق الجمود الجسدي – التجمد في المكان- في الفعل الجنسي مع المعتدي. حيث تخلق عقولنا وسائل دفاعية تُعيد رؤية المعتدي وفق تصنيفاتٍ اخترنا الثقة به على أساسها.
شُلّ عقلي من القلق والخوف، بدايةً من التفكير في “الخارج” الرافض لتجاربنا الجنسية ووجودنا نفسه، ووصولاً إلى تحليل أسباب الاعتداء. جريمة ذات شرعية، مقبولة ومُطبّعة، بوصفها فعلًا استثنائيًا مبررًا في ظرف استثنائي.
خارج هذه المنظومة المركبة من العنف والاضطهاد والخوف، نستطيع – للمرة الأولى – نزع الوصم عن أنفسنا لاختبار تجارب جنسية، والاعتراف بحقنا في أجسادنا، ونزع شعور الذنب تجاه مواجهات الرجال من عوائلنا مع المجتمعات المحيطة بنا في حال اختبرناها بشكلٍ معلن. ثم يأتي وقت نواجه فيه أنفسنا ونصنّف تجاربنا ما بين الحميمية والإكراه والاغتصاب. وتتمايز المفاهيم، بين ما اخترناه من مواجهات لانتزاع حرية أجسادنا، وبين استغلال مكتسبات حروبنا من رجالٍ اعتادوا انتهاك وتملّك أجساد النساء.
View this post on Instagram
محاولات للتعافي
أدين لوالدتي، ولجميع النساء اللواتي صنفن أنفسهن يساريات وثوريات في مجتمع حاربهن بكل ضراوة، واللواتي مهّدن للنساء من عائلاتهن بداية طريقهن للحرية.
لن ألوم نفسي، ولا أهلي الذين حاوطوني بدائرة لا تمُت لواقع مجتمعنا بِصلة، ولا انعدام الحدود التي سمحت بالحرية دون فلترة الانتهاك.
أؤمن أنه في خضم دفاعهن المستميت عن هامش حرية جنسية أوسع لأنفسهن وبناتهن وأخواتهن، سقط عنهن بناء وعي عن العنف الجنسي الذي قد نتعرض له من رجال اليسار التحرري الذين غالبًا ما مارسوه ضدهن وضد غيرهن من النساء.
أتذكّر الوصم الذي لاحق العديد من النساء التحرريّات اللواتي وضعن الحدود الجسديّة للرجال من المحيط ذاته. قيل عنهن: معقّدات، ذوات أمراض نفسية، لامنتميات، مرتابات، وبل “مستعفّات”.
حين أفكر أنني يومًا ما قد أكون أمّاً لفتاة، أؤمن أنني سأبدأ معها من حرية جسدها وحدودها التي ترسمها لأي شخص، و الحق بإيقاف الفعل الجنسي بالوقت والثانية التي تريدها. أستبدل ما تربيّت عليه بأن مَن يحترم فكرها سيحترم جسدها، وأن الناجين لن يمتنعوا بالضرورة عن ممارسة الانتهاكات.
لن ألوم نفسي، ولا أهلي الذين حاوطوني بدائرة لا تمُت لواقع مجتمعنا بِصلة، ولا انعدام الحدود التي سمحت بالحرية دون فلترة الانتهاك. في حين أفقد القدرة على الغضب في لوحة مكتملة من العنف والانتهاك والفوضى، وتتحول تجربة الاغتصاب إلى مجرد حدث مؤسف أناقشه في جلسات العلاج النفسي، وينتهي مع الدقيقة الخامسة والأربعين.
أقول لنفسي أنني أحبها كل يوم مع الندوب التي اعترتها، وأنني أقف معها وأحميها مع غياب كافة نظم الحماية لها. وأنني أحب كل النساء بجميع معاركهن، اللواتي حاربن فيها لاسترداد مساحات أجسادهن من شركائهن وما زلن يحاربن.
كتابة: ليلى العريض – اسم مستعار اختارته الكاتبة لتجهيل هويّتها.
