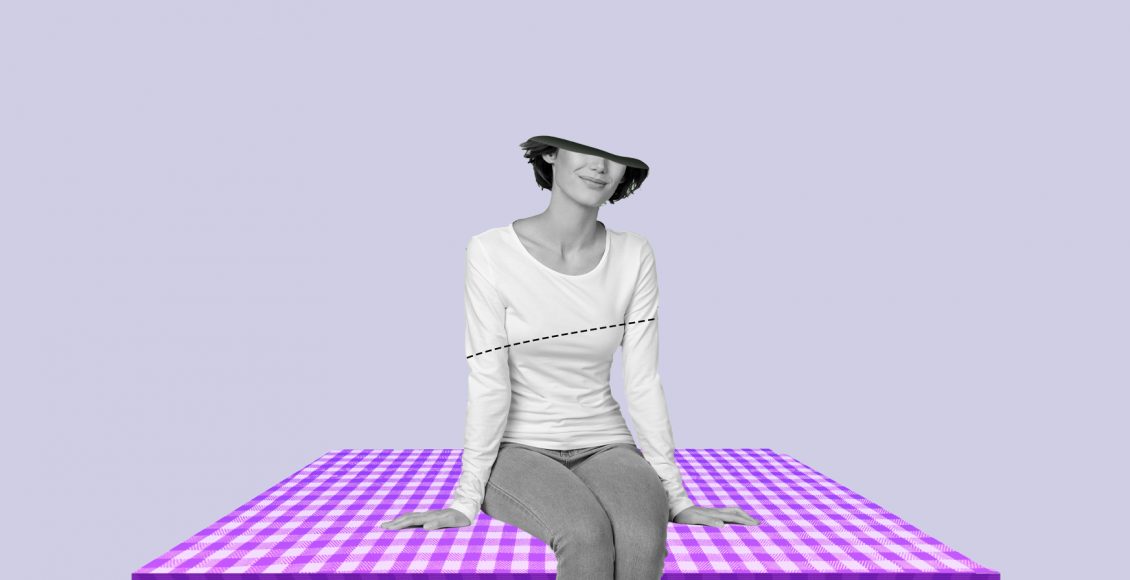
الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة.. خارج الخدمة
“مررتُ بتجربتي حملٍ متتايلتين، انتهتا بخسارتين موجعتين. لم يأخذ أحد إعاقتي بعين الاعتبار. لم تكن العيادات مجهزة، ولا الفحوص دقيقة، ولا الرعاية ملائمة، وفي كل مرة كنت أصل إلى الشهر التاسع، ثم أفقد الجنين.”
بهذه الكلمات بدأت فاطمة دعبول، وهي امرأة تعيش مع إعاقة حركية، الحديث عن تجربتها مع الحمل والولادة في النظام الصحي اللبناني. شهادتها تختصر وجعًا مشتركًا تعيشه مئات النساء ذوات الإعاقة، حين يُعاملن كأن أجسادهن لا تحمل الحق في الإنجاب، أو لا تحتاج إلى رعاية تتناسب مع خصوصياتهن الجسدية والنفسية.
بين النص والتطبيق.. أين حقوق ذوات الإعاقة؟
لطالما واجهت النساء في العالم العربي تمييزًا منهجيًا في الوصول إلى الخدمات الصحية، لا سيما ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية. وتزداد هذه الفجوة وضوحًا لدى الفئات الأكثر هشاشة، كالنساء ذوات الإعاقة واللاجئات منهن، حيث تتقاطع عوامل التمييز القائم على النوع الاجتماعي مع الإعاقة والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
ورغم وجود قوانين محلية واتفاقيات دولية تضمن الحق في الصحة والرعاية دون تمييز، إلا أن التطبيق العملي غالبًا ما يبقى معطّلًا أو خاضعًا لسياسات لا تُنصف النساء ذوات الإعاقة، ما يُبقي كثيرات منهن خارج دائرة الاهتمام الصحي والخدماتي.
“العيادات مجهزة، ولا الفحوص دقيقة، ولا الرعاية ملائمة، وفي كل مرة كنت أصل إلى الشهر التاسع، ثم أفقد الجنين.”
في لبنان، وقّعت الدولة في العام 2022 على اتفاقية دولية تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة، كما ينص القانون 220/2000 على ضمان حق الوصول إلى الخدمات الصحية دون تمييز. إلا أن الواقع يكشف عن فجوة واسعة بين النص والتطبيق، إذ لا تزال العديد من النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لمواقف غير إنسانية خلال محاولتهن تلقي الرعاية، سواء بسبب غياب البنية التحتية الملائمة، أو بسبب النظرة النمطية التي تعتبر الإعاقة حاجزًا أمام الاحتياجات الصحية، وخصوصًا الإنجابية.
يُضاف إلى ذلك حرمان هؤلاء النساء من الحصول على المعلومات المناسبة، نتيجة غياب حملات توعية موجهة إليهن، وعدم تصميم المواد الإعلامية بشكل ميسّر يلائم احتياجاتهن السمعية أو البصرية أو المعرفية. كما يواجهن صعوبات في إجراء الفحوصات الطبية الدورية، إما بسبب صعوبة الوصول إلى العيادات، أو نتيجة مواقف تمييزية من بعض مقدمي الرعاية الذين يفترضون – خطأً – أن المرأة المعوّقة لا تحتاج إلى هذه الفحوصات. وتتفاقم هذه المشكلة بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة الحركية، إذ إن جلوسهن المستمر على الكرسي المتحرّك يستدعي متابعة طبية دورية، غالبًا ما تُهمل.
وفي المقابل، تواجه النساء ذوات الإعاقة وصمة اجتماعية وترهيبًا من زيارة الأطباء في حال كنّ غير متزوجات، ولا يُسمح لهن غالبًا بالحصول على الرعاية الطبية إلا في حالات طارئة أو استثنائية.
كذلك، تضعف فرص تلقي رعاية ما قبل الولادة لدى النساء الحوامل من ذوات الإعاقة، إذ يواجهن شكوكًا مجتمعية ومهنية بشأن قدرتهن على الحمل والإنجاب، ما يؤدي إلى إهمال طبي أو غياب المتابعة المنتظمة والآمنة للحمل، تمامًا كما حصل مع فاطمة دعبول.
حقّنا في أن نُعامل كأجساد تستحق الحياة، والكرامة، والرعاية
تخبرنا فاطمة أنه “منذ لحظة اكتشافي لحملي الأول، توجهت إلى طبيبة نسائية أعرفها معرفة شخصية. لم تتعامل معي كأنني امرأة تعيش مع إعاقة. كان الحمل طبيعيًا بحسب كلامها، ولم تشر إلى أي صعوبات محتملة قد أواجهها، لا خلال الولادة ولا أثناء الحمل. طيلة الأشهر التسعة، كانت الفحوصات روتينية، والمعاينات اعتيادية”.
وأضافت: “في الشهر التاسع، أجرينا أول صورة للجنين، وكل شيء بدا طبيعيًا: النبض، الحركة، النمو. لكن بعد أيام قليلة من تلك الصورة، توقف نبض الجنين فجأة. توجهتُ إلى المستشفى، وهناك أبلغوني بأن الطفل قد تُوفي. كنت أعتقد أن هذه الخسارة كان يمكن تفاديها. الطبيبة لم تُنبّهني لأي مؤشرات خطر، ولم تُخصّص لي متابعة دقيقة رغم إعاقتي”.
“كنت أعتقد أن هذه الخسارة كان يمكن تفاديها. الطبيبة لم تُنبّهني لأي مؤشرات خطر، ولم تُخصّص لي متابعة دقيقة رغم إعاقتي”.
وأفادت: “بعد أربعة أشهر، حملت بطفلي الثاني. هذه المرة تغيّرت الطبيبة بسبب الظروف، وتابعتني طبيبة روسية كانت تزورني في المنزل وتُسهّل عليّ الكثير من الأمور، لكن، مرة أخرى، لم تأخذ إعاقتي بعين الاعتبار. كانت العيادة غير مجهّزة بالكامل: درج من دون منحدر، وعدم وجود تسهيلات لدخول الكرسي المتحرّك، أو أسرّة قابلة للتعديل”.
تابعت فاطمة: “في الشهر التاسع، وأنا في طريقي إلى المستشفى، توقف نبض الجنين مجددًا. وصلنا إلى المستشفى لأجد أن الطفل قد تُوفي أيضًا. المستشفى لم يكن مهيّئًا لاستقبال النساء ذوات الإعاقة: لا تجهيزات، لا خصوصية، ولا معاملة مختلفة، وكأن كل المريضات متساويات في القدرة الجسدية. طُلِب مني الصعود إلى السرير دون مساعدة، والمرحاض كان صغيرًا لا يتّسع للكرسي المتحرك، ويفتقر للمقابض الجانبية التي تساعد على الاتكاء”.
“لماذا لا تُخصّص لنا فحوصات دورية أو حملات توعية كباقي النساء؟ لماذا يُنظر إلينا كحالات استثنائية؟”.
وأضافت بأسى: “رغم حالتي النفسية السيئة، طلبت أن أرى الطفل لأفهم إن كان يعاني من أي مشكلة، لكنهم رفضوا، بحجة أن “رؤيته تُحزن الأم”، وأن الأمر “رحمة من الله”. أصبت بانهيار نفسي مع زوجي، وتوقفت عن محاولة الحمل لفترة طويلة”.
وأوضحت: “بعد ست سنوات ونصف، حملت بطفلي الثالث. عدت للطبيبة نفسها التي تابعت حملي الأول، لأنها كانت تمنحني شعورًا بالارتياح. قالت لي: “لو كانت لديكِ مشكلة أو كان حملك مستحيلًا، لما كنتِ وصلتِ إلى الشهر التاسع في كل مرة.” هذه الجملة أعادت لي شيئًا من الثقة. تابعتني عن قرب، وخضعت لمراقبة يومية للنبض ولحركة الجنين، وفي أول جمعة من الشهر التاسع خضعت لولادة قيصرية وأنجبت ابنتي الأولى”.
ثم أضافت: “بعد عامين، حملت بابنتي الثانية. أيضًا، تابعت مع الطبيبة نفسها، وخضعت لولادة قيصرية مبكرة في بداية الشهر التاسع، وطلبت بنفسي البقاء في المستشفى تحت المراقبة نتيجة التوتر والخوف من تكرار التجربة القاسية”.
“أعرف إحداهن وُضعت قسرًا في مستشفى للأمراض العقلية رغم سلامتها الذهنية، فقط لأنها مقعدة. نُقلت إلى مدينة بعيدة عن أهلها وماتت هناك، وحيدة، بلا حماية”.
واستذكرت: “في كل التجارب السابقة، كنت أُنصَح بالمشي لتحفيز الولادة، من دون مراعاة أني أعاني من إعاقة، وأن المشي قد يكون مرهقًا أو خطرًا على الجنين في حالتي. هذا الجهل أو عدم الوعي الطبي بطبيعة الإعاقة قد يكون أحد أسباب فقدان طفليّ الأول والثاني”.
واختتمت شهادتها بقولها: “ما أتمناه هو أن يتعلّم أطباء النسائية كيفية التعامل مع النساء ذوات الإعاقة، ليس فقط نفسيًا، بل أيضًا من حيث الوضعيات الجسدية، الفحوصات المناسبة، والحاجة للتنسيق مع اختصاصيين/ات آخرين/ أخريات حسب نوع الإعاقة. من غير المقبول أن تكون العيادات غير مهيّأة: لا منحدرات، ولا مصاعد، ولا مراحيض تناسب الكراسي المتحرّكة. حتى النساء غير المعاقات يجدن صعوبة في صعود الدرج خلال الحمل، فكيف بنا نحن؟”.
وسألت بأسى: “لماذا لا تُخصّص لنا فحوصات دورية أو حملات توعية كباقي النساء؟ لماذا يُنظر إلينا كحالات استثنائية؟”.
وأضافت: “أحمل بطاقة شؤون اجتماعية منذ سنوات، لكني لم أستفد منها صحيًا: لا دواء، لا متابعة، ولا مستشفى. حتى الطبيب الذي أثق به لم أعد قادرة على زيارته، لأنه في طابق مرتفع بلا مصعد”.
وختمت: “وما يؤلمني أكثر هو مصير النساء ذوات الاعاقة الأكبر سنًا. أعرف إحداهن وُضعت قسرًا في مستشفى للأمراض العقلية رغم سلامتها الذهنية، فقط لأنها مقعدة. نُقلت إلى مدينة بعيدة عن أهلها وماتت هناك، وحيدة، بلا حماية”.
أبرز العقبات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة
في مداخلة للسيدة لينا صبرا، المديرة التنفيذية لمنظمة “سلامة”، وهي جمعية تعنى بالصحة الإنجابية والجنسية في لبنان، توضح أن النساء ذوات الإعاقة في لبنان يواجهن سلسلة من العوائق المتداخلة في ما يتعلق بحقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية، بدءًا من البنية التحتية غير المؤهلة، وصولًا إلى التمييز الاجتماعي والثغرات القانونية.
تقول: “ما زالت النساء ذوات الإعاقة يُعاملن كحالات استثنائية، بينما يُفترض أن يكون اختلاف الجسد جزءًا طبيعيًا من التنوع البشري، لا مبررًا للتمييز أو الإقصاء”.
وتعدّد صبرا أبرز هذه التحديات، ومنها الحواجز الفيزيائية في المستشفيات والعيادات، وعدم ملاءمتها لاحتياجات النساء المقعدات، إضافة إلى نقص وسائل النقل المهيّأة. كما تبرز مشكلة غياب التدريب المتخصص لدى مقدّمي/ات الرعاية الصحية، وندرة وجود مترجمي/ات لغة الإشارة أو وسائل تواصل بديلة، مما يضاعف صعوبة تلقي الخدمات. أما على المستوى الاجتماعي، فتقول: “لا تزال النظرة التقليدية تحرم النساء ذوات الإعاقة من حقهن في الأمومة والعلاقات الجنسية، وتُفرض عليهن قرارات طبية أو عائلية من دون موافقتهن، في ظل افتراضات خاطئة حول قدراتهن أو رغبتهن”.
وتضيف أن نقص المعلومات والتثقيف الجنسي يفاقم هذه الفجوة، حيث لا توجد برامج وطنية مستدامة لتقديم محتوى تثقيفي مكيّف مع أنواع الإعاقات المختلفة، ما يحدّ من قدرة النساء على اتخاذ قرارات مستنيرة. ورغم أن القانون اللبناني 220/2000 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينصّان على حق الرعاية الشاملة، إلا أن الالتزام الفعلي يكاد يكون معدومًا، سواء من قبل الدولة أو المؤسسات الطبية. لا رقابة تُذكر على جهوزية العيادات، ولا سياسة تدريب إلزامية من نقابة الأطباء أو وزارة الصحة.
مع ذلك، تسعى بعض المنظمات لردم هذه الفجوة، وتقول صبرا: “أسسنا شراكة مع الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين/ات حركيًا، حيث قمنا بتدريب عدد من كوادره في مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية، وننفذ جلسات توعية وخدمات ميدانية”. لكنها تشدد في المقابل على أن هذه المبادرات تبقى فردية ومحدودة، وتفتقر إلى الدعم المؤسسي والتنسيق بين الجهات الفاعلة.
وتختم صبرا رسالتها بالتأكيد على أن العدالة الصحية لا تتحقق إلا حين يُعامل الجسد المختلف كحق لا كاستثناء: “لكل امرأة، بغضّ النظر عن الإعاقة، الحق في الرعاية التي تحترم كرامتها وتراعي خصوصيتها. الجسد المختلف ليس نقصًا، بل شكل آخر من الإنسانية يستحق أن يُرى ويُحترم”.
فجوة بين المستوصف والعيادة الخاصة
تتكرر معاناة النساء ذوات الإعاقة في سياقات متعدّدة، وقصة نهاد تعيد فتح السؤال عن الحاجة الملحّة إلى حماية اقتصادية واجتماعية تضمن لهن حقّ الرعاية والكرامة.
“نقص في التعقيم، أدوات غير كافية، وفحص سطحي لا يمنح الشعور بالأمان أو الاهتمام”.
تحكي نهاد، لديها إعاقة بصرية جزئية، عن الفوارق بين الرعاية الصحية في العيادات الخاصة والمستوصفات العامة، لا سيّما في ما يتعلق بصحة النساء. “رغبتُ في التخفيف من التكاليف الباهظة للمعاينات الطبية، فقررتُ الذهاب إلى مستوصف برفقة إحدى صديقاتي. ظننت أن المعاينة ستكون مشابهة لما اختبرته في العيادات الخاصة، لكنّني فوجئت بتجربة مختلفة تمامًا، نقص في التعقيم، أدوات غير كافية، وفحص سطحي لا يمنح الشعور بالأمان أو الاهتمام. حتى طريقة المعاملة لم تكن كما ينبغي، ما جعلني أتردد في تكرار الزيارة، رغم معرفتي بأنّ عليّ الخضوع لفحوص دورية كل ستة أشهر.”
“كانوا يسألونني إن كنت أفضل وجود زوجي أثناء الفحص أم لا، ويتركون القرار لي. تمنيتُ لو أن هذا المستوى من الرعاية متاح لجميع النساء.”
وتتابع نهاد الحديث عن تجربتها مع الطبيب النسائي في العيادة الخاصة “منذ سنوات، راجعت طبيبًا نسائيًا في بيروت بعد اكتشاف مشكلة صحية في الرحم. شعرتُ منذ اللحظة الأولى بالاحترام والرعاية. أُجريت لي الفحوصات اللازمة، ثم خضعتُ لعملية جراحية، وكل ذلك وسط تعامل إنساني دقيق واهتمام واضح. بعد زواجي، واصلت زيارة الطبيب نفسه. كانوا يسألونني إن كنت أفضل وجود زوجي أثناء الفحص أم لا، ويتركون القرار لي. كانت كل زيارة تتم بهدوء، مع شرح واضح وإرشاد في كل خطوة. تمنيتُ لو أن هذا المستوى من الرعاية متاح لجميع النساء، في كل المراكز الصحية، وليس فقط في العيادات الخاصة.”
شهادة نهاد تكشف الفجوة الكبيرة في الرعاية الصحية التي تتلقاها النساء ذوات الاعاقة في العيادات كأن الرعاية تشمل طبقة محددة من النساء لتبقى النساء الاخريات رهينة للاهمال والتهميش ويسلط الضوء على دور وزارة الشؤون الاجتماعية من هذا التغييب القسري لدورها في حماية النساء ذوات الاعاقة من حيث الرعاية والتوعية حول صحتهن الجنسية والانجابية والتي نصت عليها القوانين المحلية والدولية.
النساء ذوات الاعاقة في الاتفاقيات الدولية
تنص المادة 25 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة على حقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة دون تمييز، بما يشمل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتُلزم الدول بتوفير رعاية صحية متخصصة وميسّرة، وضمان موافقة المستفيدين الحرة والمستنيرة، وتدريب الطواقم الطبية على احترام كرامة الأشخاص ذوي/ ذوات الإعاقة.
تشير دراسة نُشرت على موقع PubMed (ديسمبر 2024) إلى أن النساء يشكّلن نحو 75% من الأشخاص ذوي/ ذوات الإعاقة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ما يجعلهن عرضة لتهميش مضاعف نتيجة تقاطع الإعاقة والنوع الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلق بالوصول إلى الرعاية واتخاذ قرارات صحية مستقلة.
في لبنان، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية والانهيار الصحي، تكشف البيانات المجمعة من 38 مركزًا لإعادة التأهيل أن النساء ذوات الإعاقة شكّلن أقل من 20% من المستفيدين، ما يبرز فجوة حادة في التغطية. ويُعزى ذلك إلى سياسات تقصي النساء ذوات الإعاقات غير الظاهرة، وغياب بنى تحتية ملائمة، وتكاليف باهظة، ما يحدّ من قدرة النساء على الوصول إلى الرعاية، رغم تصنيف لبنان كدولة متوسطة الدخل.
الحق في الصحة ليس امتيازًا
فاطمة ونهاد لسن الوحيدات اللواتي تعرضن للتمييز بل هن يشكّلن فئة كبيرة من النساء المهمشات اللواتي يتعرضن لمختلف أنواع التمييز والاهمال لا سيما في ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية. هذا الفشل لا يكمن فقط في غياب البنية التحتية أو ضعف التدريب، بل في النظرة المجتمعية والسياسية التي لا تزال تُقصي هذه النساء من دوائر القرار والرعاية، وتُنكر عليهن حقّهن الكامل في الجسد، والكرامة، والمعلومة، والمرافقة الطبية الملائمة.
المطلوب اليوم أن يتحوّل الاعتراف بحقوق النساء ذوات الإعاقة من شعارات في الاتفاقيات والنصوص إلى التزام فعلي تُبنى عليه سياسات عامة عادلة، وتُرصد له الموارد، ويُحاسب على غيابه. العدالة الصحية لا تتحقق بمجرد إلا بضمان تطبيق القوانين واحترام حقوقهن، حرفيًا ومجازيًا، لكل النساء، بكل اختلافاتهن وتجاربهن.
كتابة: ناهلة سلامة
