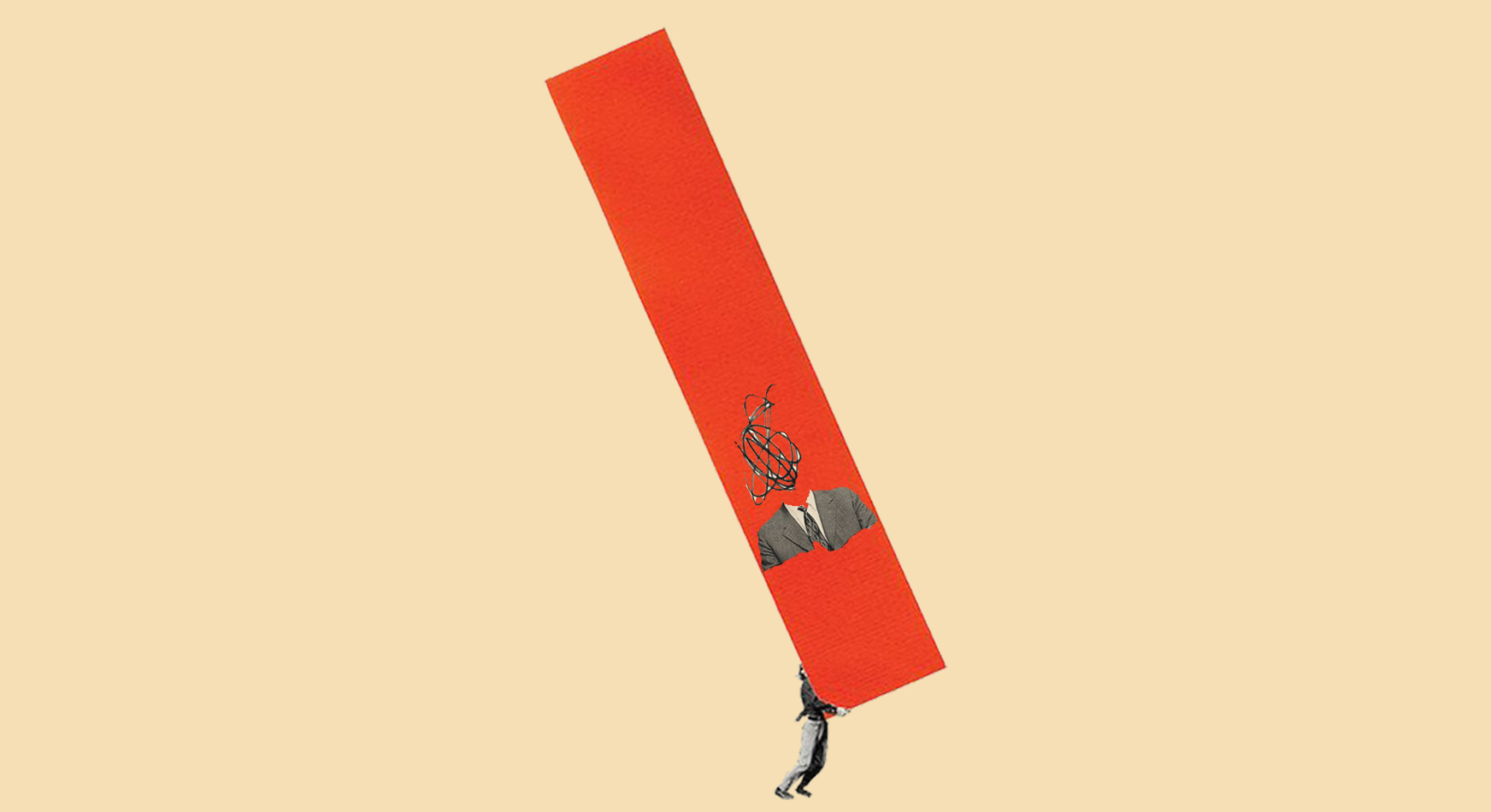
21 عاماً على وفاة أول شخص تحرّش بي… التحرش في “الدوائر الآمنة” موجع ولا يمكن تجاوزه
كان صباحاً عادياً رافقني معه فنجان النسكافيه وبسكويتي المفضل بالشوكولا، كما صباحات يوم العطلة التي نأمل منها الراحة والاسترخاء. كنت أتصفح منشورات الأصدقاء على فيسبوك باهتمام بعد 5 أيام من الغياب. بعض الأحداث المفرحة فاتتني، والكثير من المنشورات الموجعة التي تلائم مشاعر فترةٍ جديدةٍ مؤلمة أيضاً بسبب كوفيد 19 وما يرافقها من مشاعر حزنٍ وقلق.
فجأة، وقعت عيناي على هذه الصورة التي لا أستطيع تجاوزها حتى اليوم، بعد مرور عدة أشهر. إنها صورة لأول شخصٍ تحرش بي جنسياً في طفولتي، شاركها ابنه – صديقي المقرب الذي نشأت معه دراسياً واجتماعياً منذ كنت في السادسة من عمري فقط. كتب عليها: “21 عاماً مرت على رحيلك يا غالي والحياة لا تُحتمل من بعدك. كنت أحن قلب وأفضل أب”.
لاحظت على المنشور، عشرات الدعوات بالرحمة للمتوفى وبالصبر على الفراق لذويه. انقلب مزاجي الصباحي وأغلقت الهاتف. ولا أدري أيهما أزعجني أكثر، صورة هذا الشخص صاحب الوجع في صدري الذي لا يخفت أبداً، أم دعوات الترحم التي تعكس جهل أصحابها بقذارته؟
بعد مرور 21 عاماً، لا أحتمل أن يُصوّر كالملاك ولا أجرؤ على فضحه. لا أنسى أيضاً ذلك اليوم قبل نحو 22 عاماً، حين كان ضيفاً لدينا، وهو صديق والدي المقرب وشريكه في العمل، ذهب والدي ليتوضأ للخروج معه إلى الصلاة في المسجد، وذهبت والدتي لتعد له واجب الضيافة، بينما بقي هو في مقعدٍ مواجهٍ لي بمفردنا في صالة المنزل نشاهد التلفزيون.
بشكلٍ غير متوقع، نظر إلي نظرةً حقيرةً وحاجباه يتحركان ثم أشار بيديه إلى ثديّي في ما فهمت منه أنه يقول إنهما كبرا وأصبحت “أنثى”. كنت في الـ12 فقط من العمر، وفي مرحلةٍ مضطربة جداً مع جسدي الذي كان ينمو بشكلٍ لا أحبه. هذان النهدان جادلتني والدتي كثيراً قبل هذا الموقف لأخفي نموهما بارتداء حمالة صدر (سوتيان) تشل اهتزازهما مع كل حركة. لكنني رفضت دوماً باستماتة، ربما كنت أظن أن أحداً لا يلحظهما أو أن ارتداءها سيكون اعترافاً مني بأنني صرت ناضجة “الأنوثة” أو أن رفضها حيلة ستؤخر هذا المصير.
كسرني هذا الموقف في ذلك السن، لم أكن أفهم معنى التحرش ولم أكن قد اختبرته سابقاً. بل لم يكن هذا المصطلح متداولاً أصلاً. كان الأمر عادة يعرف بـ”المعاكسة”. خلال الموقف، شعرت بعدم راحة وغضب وضيقٍ وانكسار. كنت طفلةً قويةً وجريئةً، لكنني طأطأت رأسي حين فعل ذلك، وخضعت من دون جدال لرغبة والدتي في ارتداء حمالة الصدر، حتى أنني لُمت نفسي وأخبرتها مراراً أنها المخطئة وأنه لم يكن ليتحرّش بي لو كنت ارتديتها.
مرت الأيام، وتكررت حوادث التحرش بي – أحد الجيران حاول استدراجي إلى بقعةٍ مظلمة في منزلهم الملاصق لمنزلنا وملامسة أجزاء حميمة من جسدي، فصرخت وهربت منه. وذاك المدرس الذي كان يستغل صغر سن طالباته وسذاجتهن ليتحسّس نهودهن وهي في طور النمو، متظاهراً بـ”زغزغتهن”. وكنت أنا ضحيته لمرةٍ واحدة حرصت بعدها أن لا أسمح له بالاقتراب مني. والغريب في سيارة الأجرة الذي تظاهر بالنوم ومد يده لتلامس ثديي. والشخص الذي حاول ملامسة فخذي على سلم المترو .. قائمة لا تنتهي ومرشحة للزيادة طالما أعيش في مصر.
لكنني أزعم أنني نجحت في الهروب من الكثير من هذه المواقف والتغلب على هذه الذكريات. فأنا بارعة في الهروب من المواقف والذكريات الأليمة، لكنني أبداً لم أتسامح مع أول حادثة تعرضت لها ومرتكبها، صديق والدي.
ربما أفهم الآن لماذا. بينما لمت نفسي مراراً على هذا الموقف في الصغر، أدرك حالياً تمام الإدراك كم كان هذا الشخص مجرماً وحقيراً، وأنه الوحيد الملام في هذا الموقف. لم يكن مفترضاً أن ينتهك المنزل الذي اؤتمن عليه وحظي أبناؤه فيه بالدفء والرعاية. بدد هذا الخسيس شعوري بالأمان داخل منزلي إلى غير رجعة، وأفقدني ثقتي في نفسي، والأخطر من ذلك حبي لجسدي.. لم أتمكن ثانيةً من استعادة الثقة في قدرة هذا الجسد على حمايتي. بتت أعتبره نقطة ضعف، وهذا أمر مؤلم جداً أن أشعر به أو أفصح عنه.
التحرش بالأطفال والطفلات في الدوائر الآمنة
الحادث الذي تعرضت له أمر شائع من أشكال الإساءة والاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال والطفلات خصوصاً في “الدوائر الآمنة” لهن/م والتي تقع في نطاق المنزل والأسرة، وحتى العائلة الأوسع. إذ تخشى الطفلات الإفصاح عما تعرّضن له بسبب خوفهن من عدم تصديقهن، أو لعدم فهمهن وإدراكهن لحقيقة أن هذا الأمر لا ينبغي أن يحدث، بينما يتمتع المعتدي/المسيء بسلطةٍ أكبر تمكنه من الاستمرار في أفعاله.
لهذا أيضاً، يوصي الخبراء بعدم ترك الطفلات والأطفال يغيبون/ن عن نظر الأب أو الأم مع آخرين أياً كانت الصلة بهم/ن، وإشعار الطفلات والأطفال دائماً بالأمان للبوح والتحدث عما يزعجهن/م مهما كان بسيطاً. كما يُنصح بملاحظة أي تغير في سلوكهن/م سواء كان ذلك بشكلٍ عام أو تجاه شخصٍ بعينه في إطار العائلة والمعارف.
بعد شهورٍ قليلة من الحادثة، تدهورت صحة هذا المتحرش وتوفي. كنت أسمع أحاديث عن آلامه فأشعر بارتياحٍ نسبي وأقول في نفسي: “يستحق كل الألم كما آلمني”. لست شخصاً انتقامياً أو بلا رحمة، لكن لماذا أتألم وهو يعيش مرتاحاً بينما هو سبب معاناتي وأنا لم أضره في شيء؟
في محاولات التخفيف عن زوجته وأبنائه كان الكثيرون يقولون إن مآله الجنة، إذ يسود اعتقاد أن “المبطون شهيد”، وهو توفي بداء الكبد. كطفلة، كنت أتساءل كيف يدخل الجنة وهو بهذه الحقارة وأين هي عدالة السماء إن حدث؟
الآن، لا يهمني مصيره كثيراً لكن لا تزال تزعجني عبارات الترحم عليه. أود أحياناً أن أصرخ وأقول إنه لا يستحقه، أتذكر أنه لا يمكنني قول ذلك من دون بيان السبب فأسكت.
ربما لم أبُح إلى المقربين/ات بفعلته إشفاقاً على والدي أن يُصدم في “أعز صديقٍ له”، الذي انتهك منزله وفي حضوره ومع طفلته.
ربما أخشى أيضاً على أبنائه، الذين أحبهم ويبادلونني المودة، من صدمتهم في من يرونه “أعظم أب” حين يكتشفون أنه تحرش بطفلة صديقه وصديقتهم.
لا أدري السبب، لكنني أكيدة أنني لا أرغب في الحديث عن هذا الموقف في دائرتي المقربة، ربما لهذا أكتب الآن علّها تغادرني وأشعر ببعض السكينة.
