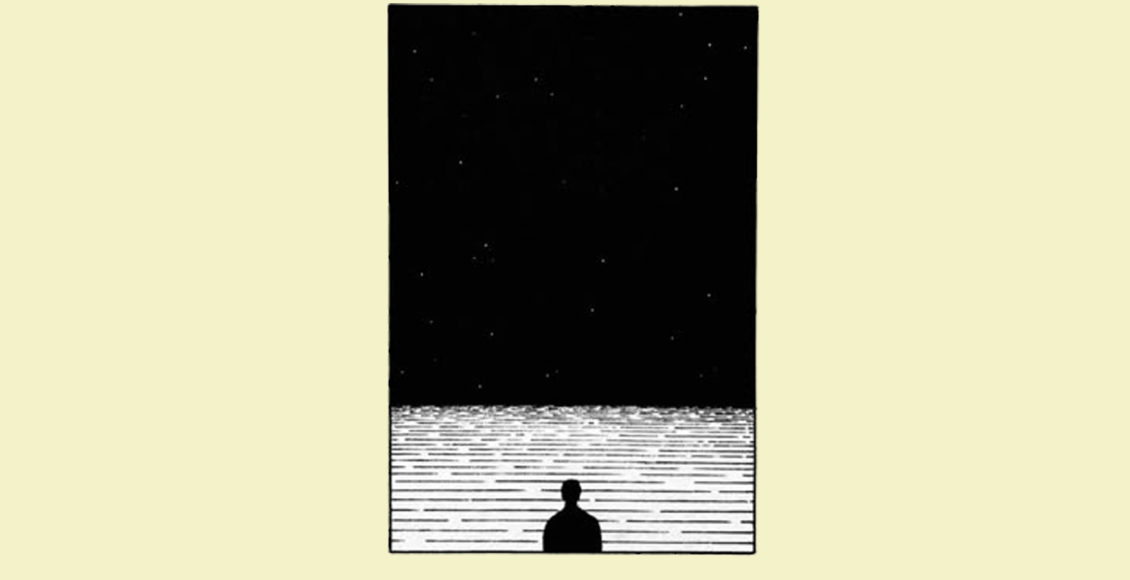
البينية الجنسية في تونس.. تهميش وإقصاء وعزلة مدى الحياة
تنطوي البينية الجنسية اصطلاحًا على كل الأشخاص اللاتي/الذين يولدن/ون خلافًا للمعايير الأبوية والجنسانية. وتعرّف هذه المعايير الجنس البيولوجي بثنائية ذكر وأنثى، وتربطه بالهوية الاجتماعية – الجندر – رجل وامرأة.
يُحدد الجنس البيولوجي الثنائي وفقًا لعدة عوامل، منها الأعضاء الجنسية الخارجية عند الولادة، الكروموسومات، والهرمونات. إلا أن المعايير الأبوية، المتوغلة في القطاع الطبي وطواقمه، تعتمد في تحديد الجنس الثنائي على الأعضاء الجنسية الخارجية فقط عند الولادة.
وهو ما يضع الأشخاص المولودات/ين بعوامل أخرى مُحددة للجنس مثل الهرمونات والكروموسومات تحت سلطة تحديد الجنس وفقًا لطبيب/ة التوليد. هذا بالإضافة إلى إنكار وجود أشخاص خارج الثنائية البيولوجية من الأساس. فالشخص إما ذكر أو أنثى، وفقًا لهذا المنظور.
وإذا كان علميًا الكروموسوم أو الخلايا التي تحدد جنس الجنين XX تشير إلى الأنثى، والكروموسوم XY يشير إلى الذكر، فإن هناك أشخاص يمتلكن/ون كروموسوم X فقط، أو XXY. وهو ما يجعل عملية تحديد الجنس، وفقًا للثنائية المذكورة، أمرًا إشكاليًا. وبالتالي، يندرج هؤلاء ضمن الأشخاص البينيات/ين.
محرومات/ون من كل الخدمات العمومية وخصوصًا الصحية، هروبًا من الوصم ونظرات الاحتقار والتساؤل والتمييز.
البينية الجنسية.. بين الجنس البيولوجي والنوع الاجتماعي
على مدار قرون، اعتمدت الأنظمة الأبوية على التصنيفات والتقسيمات المُحددة للبشر. فيما أغفلت، عن عمدٍ، التنوع والثراء المتواجد في الحياة بوجهٍ عامٍ.
من أبرز هذه التصنيفات هو التصنيف البيولوجي للأشخاص بين الذكورة والأنوثة فحسبٍ، ليتوافق التصنيف للهويات الاجتماعية كذلك بين الرجولة بوصفها ترجمة أدائية للذكورة، وبين النسائية بوصفها أداء للأنوثة. قدّمت الأبوية هذه الثنائيات باعتبارها الشكل الوحيد لما يُمكن أن يكونه الأفراد. ويترتب عليها حيواتهن/م وتعاملاتهن/م مع المحيط الاجتماعي والسياسي الاقتصادي خلال هذه الحيوات.
أنكرت هذه التصنيفات وجود أشخاص خارجها، أو رافضات/ين لها، وهن/م ما يعرفن/ون بـاللامعيارية – أي خارج المعيار الأبوي الثنائي للجنس والهوية الاجتماعية. أصبح كل شخص لا يتوافق/يتوافق جنسه/ها البيولوجي مع الهوية الاجتماعية (الجندر)، محل تمييز ووصم وعنف. وأصبح كذلك غالبية البشر مصنّفات/ين بالفعل ضمن ثنائيات ذكر/أنثى = رجل/امرأة.
بسبب هذه المعيارية الأبوية، قام التاريخ بأكمله، بما فيه اللغة والبناء الاجتماعي والكيانات السياسية والأنظمة الاقتصادية، على وجود جنسين وهويتين اجتماعيتين فقط للبشر. وهو ما كان أسهل في بداية شراكة الرأسمالية والأبوية تاريخيًا، بسبب قيامهما على فكرة العائلة الغيرية (رجل وامرأة وأطفال/طفلات).
في غضون هذه القرون، أُنكر على الأشخاص اللامعياريات/ين حق الوجود في المطلق. وأجبر بعضهن/م على التظاهر بالتوافق بين الجنس البيولوجي والهوية الاجتماعية، من أجل النجاة بحيواتهن/م. وفي هذه الأثناء أيضًا، تعرضن/وا إلى أنواع وحشية من العنف والإقصاء بسبب الاختلاف الجنسي، أو الجنساني، أو الجندري.
خلال القرن العشرين، شهدت النظرية النسوية طفرة في نقد الربط الأبوي بين الجنس البيولوجي والهوية الاجتماعية، وحصرهما في ثنائيات تُنكر حق الحياة والوجود على الأشخاص غير المعياريات/ين. إذ فككت النسويات فكرة ثنائية الجنس بالاعتماد على الإثبات العلمي أن جميع البشر يقعن/ون بين الأنوثة والذكورة. وكذلك تتعدد الهويات الاجتماعية وتخرج أحيانًا كثيرة عن ثنائية رجل/امرأة في مجتمعاتٍ نجحت في النجاة من الاستعمار الأبيض ومركبّات الحداثة.
في قراءة كتاب “قلق الجندر: النسوية وتخريب الهوية” للكاتبة الأميركية جوديث بتلر، نجد تحليلًا عميقًا للربط الأبوي بين الجنس عند الولادة والنوع الاجتماعي. تسترجع الكاتبة طفولتها وتفكك خيوط الهويات، مراهنةً على “إعادة التفكير الجذري في البناءات الأنطولوجية للهوية بغرض تحرير النظرية النسوية”، حسب قولها.
هذا الربط الأبوي والذي يبدأ أساسًا من تحديد اللغة والنحو في مخاطبة الأشخاص “هو و هي”، يتجاوز خلق أزمة هوية للأشخاص اللامعياريات/ين ليصل إلى شرعنة وشرعية أنطولوجية داخل الفضاء العام. يؤكد ذلك نظرية بتلر في أن “تغيير الجندر سيتم عبر الطعن في النحو الذي تشكَّل في نطاقه”.
ومن هذا المنطلق، وعند تفكيرنا في الهوية الاجتماعية المربوطة بالجنس البيولوجي والمقتصرة على ثنائية (ذكر/ أنثى) (رجل/امرأة)، نجد أن البينيات/ين جنسيًا هن/م أول من يتم محاسبتهن/م وجلدهن/م في ثنائية الهو والهي. هن/م الواقفان/ون في مفترق طرق بين عوامل محدودة وقاصرة لتعريف الأشخاص بيولوجيًا بين الأنوثة والذكورة، والمتعرّضات/ون للوصم والتمييز، بسبب عدم وقوعهن داخل الثنائية.
أصبح التصنيف البيولوجي والاجتماعي وسيلة للربط الأبوي بين الجنس عند الولادة والنوع الاجتماعي، وأنتج أشكالًا متعدّدة للوصم الاجتماعي والأخلاقي وضعت البينيات/ين في صراع دائم مع المجتمع بمنظومته القانونية والأخلاقية والتواصلية من جهة، ومع الذات كتعبير وإنتاج للهوية البيولوجية والجندرية والفكرية من جهة ثانية.
“ذهبت إلى “مستشفى أطفال باب سعدون” بتونس العاصمة، لأعيد التثبّت من ملفي الطبي. لكنني فوجئت بخلو الملف من أية معطيات طبية.” بهذه الشهادة المشحونة بالألم والتردد والبحث تبدأ آمنة العرفاوي سرد رحلته/ها مع البينية الجنسية. رحلة مليئة بالاكتشاف والبحث، ومواجهة مجتمع ذكوري محافظ يمقُت الاختلاف ويصم الأشخاص اللامعياريات/ين.
هي شهادة من شهادات عديدة اخترن/اختار صاحباتها/أصحابها عدم البوح بهويتهن/م. لكنهن/م لم يترددن/وا في التعبير عن القسوة الاجتماعية والصحية التي يواجهنها/ونها كلما تجاوزن/وا عتبة المنزل وتشاركن/وا الفضاء العام مع أفراد المجتمع باختلافاتهن/م الجندرية والجنسانية والثقافية.
View this post on Instagram
البينية الجنسية في المحاكم التونسية
تعود أول قضية لتغيير الهوية رفعت أمام أنظار المحاكم التونسية إلى تسعينات القرن الماضي، عندما رفعت سامية قضية لتغيير الجنس. زعزعت هذه القضية معايير المحكمة التونسية التي لم تكن جاهزة لمواجهة قضية من هذا النوع. فارتأت إلى رفض تغيير الهوية الثبوتية لسامية والتي كانت مصنفة “ذكرًا” في الأوراق الثبوتية.
قامت سامية أولًا بالتوجّه إلى إسبانيا لإجراء عملية جراحية غيرت بها الأعضاء الجنسية، بعد ملاحظة تغير طبيعي في جسدها على غرار نمو النهدين. كانت سامية آملة في إنصاف قضائي، لكنها اصطدمت بحكم كتب في ورقاته الأولى: “إذا ولد الشخص ذكرًا وأقر بذلك أمام المحكمة عندما وقع التحرير عليه، فإنه لا يُمكن أن يوصلنا الفقه الإسلامي إلى حل ثابت ومعلوم، باعتبار أنه تعرض بإطناب إلى وضعية «الخنثى»”.
من هنا، واجهت سامية منظومة أخلاقية ودينية، رغم ولوجها إلى منظومة قضائية تعود في أغلب أحكامها بالنظر إلى القانون الفرنسي المقارن. حاملة رفقة دفاعها، الأستاذ عمر الصفراوي، ملفًا طبيًا لا يقبل التشكيك أو الرفض.
هذه القضية، والتي فتحت الأبواب أمام البينييات/ين للمطالبة بحقوقهن/م في تغيير أو “تصحيح الجنس”، تتجدد نتائجها المنتهية بالرفض، كلما طرح مجتمع البينيات/ون مشكلة تغيير الهوية الجندرية في الأوراق الرسمية.
تقوم المحكمة بتغيير الجنس في الحالة المدنية إن رفع الأبوين قضية لتغيير الاسم، حسب القانون عدد 3 من سنة 1957 المتعلّق بتنظيم الحالة المدنية قبل بلوغ الطفل/ة سن الرشد، وبإذن من مستشفى الأطفال الحكومي. وذلك حسب شهادات بينيات وبينيين قامت منصة “شريكة ولكن” بمحاورتهن/م.
يحمل العديد من البينيات/ين وجعًا دفينًا من الأذون الصادرة عن مستشفى الأطفال. آمنة العرفاوي، ناشط/ة بيني/ة جنسي/ة ومؤسس/ة جمعية “مسارات” -كما عرّفت نفسها. آمنة من عديد البينيات/ين اللواتي/الذين غيرن/وا الجنس في الأوراق الثبوتية. هذا بعد تقرير أصدره المستشفى الحكومي يفيد بأن الجنس الأقرب إليه/ها هو أنثى، بعد إجراء بعض التحاليل وتدخل جراحي له/ها بعد موافقة الأم والأب.
وقف/ت آمنة أمام أنظار المحكمة رفقة أبويها في السابعة من عمرها. وافقت المحكمة على التغيير، شرط أن يتم تقديمه/ها في جلسة تالية وهي “ثاقبة للأذنين وواضعة حلق”. هذا هو المعيار الذي حدد اقتناع المحكمة بالجنس البيولوجي لآمنة و إصدار حكم بقبول القضية.
“تشتتت هويتي منذ أن تم تحديد جنسي على أنني أنثى. لا أعلم لماذا قاموا بتدخل جراحي وأنا مازلت في مرحلة الطفولة. أنا اليوم في العشرينات من عمري ولا أعلم إن كنت ذكرًا أو أنثى. أشعر تارة بأنني ذكر، حين يتعامل الناس معي على أنني ذكر، لمجرد أن ملامحي تحيل على الذكورة أكثر. وأشعر تارة أخرى بأنني أنثى. أحمل الإثنين معًا ولم أجد ذاتي إلى الآن”.
حاول/ت آمنة البحث في ملفها الطبي بعد كل تلك السنوات. أراد/ت أن تعرف العامل الطبي الذي جعل من الأطباء يتوصلون إلى أنها أنثى. لكنه/ها لم تجد أية أوراق رسمية تثبت التدخل الجراحي. هذه التدخلات الجراحية يشكو منها العديد من البينيات/ين اللواتي/الذين تم اختيار جنسهن/م من قبل الأبوين – حسب رغبتهما في بعض الأحيان في جنس المواليد الذي يفضلونه – ودون أي أساس علمي، حسب الناشطة في جمعية “دمج” ناجية منصور.
يناضلن/ون من أجل الأمل، ليتمكنّ/وا من ممارسة الحق في العيش بكرامة، والحق في النفاذ إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والصحية، دون وصمٍ أو تمييز أو احتقار أو اعتداء. هو حق من أجل الحياة.
الوصم الاجتماعي والخوف من المواجهة وعدم المعرفة
يندرج الوصم الاجتماعي حسب معجم “مفاهيم أساسية في علم الاجتماع” لأنتوني غيدنز وفيليب صاتن ضمن “السمات الجسدية أو الاجتماعية التي يُنظر إليها باعتبارها تحط من قدر الشخص أو أنها مستنكرة اجتماعيًا. فتؤدي إلى الخزي والهوان، والابتعاد الاجتماعي أو التمييز”. وباعتبار أن البينيات/ين والمنتميات/ين إلى مجنمع الميم عين بصفة عامة هن/هم أشخاص لا معياريات/ين، يجدن/ون أنفسهن/هم في حلقة إنتاج للوصم والتمييز.
تطرح ناجية منصور أهم ما يمكن أن يعيق البينيات/ين الجنسيات/ين على التواصل. فعدم القدرة على تعريف الذات والتشتت بين الهويات والتساؤل حول شعور الشخص تجاه ذاته/ها إن كان/ت ذكرًا أو أنثى، أو بينية/بينيًا أو لا معيارية/معياريًا أو عابرة/عابرً جندرًيا، يدفع بالعديد منهن/م إلى عدم التواصل مع الجمعيات التي تعنى بمجتمع الميم عين، محمّلات/ين بوصم وخوف اجتماعي لا يهفت. وهذا يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد إحصائيات دقيقة أو تقريبية حول عدد البينيات/ين الجنسيات/ين في تونس.
المعاناة من الوصم تؤدي بالعديد منهن/م إلى مشاكل نفسية وهرمونية، كما يشرح الأخصائي النفسي والجنساني أنس العويني. فهن/م يعيشون في “حجر مدى الحياة” وعزلة اجتماعية لتفادي كل تصادم مع الآخر. هذا التصادم من شأنه أن يلحق بهن/م ضررًا ماديًا ونفسيًا دون إنصاف أمني أو قضائي. هذا فضلًا عمّا يُمكن أن يتعرضن/وا له، في حال كانت هويتهن/م الجندرية غير مطابقة للأوراق الثبوتية.
يشير الأخصائي النفسي أنس العويني أيضًا إلى “أزمة الهوية” التي يمكن أن تؤثر سلبًا على البينيات/ين، باعتبار أنهن/م يولدن/ون خارج التصنيف الثنائي المحدود للجنس البيولوجي. وبالتالي، يضعهن/م ذلك في مفترق طرق حول ما هو الجنس الذي عليّ أن أكونه أو أن أتظاهر به. تشير آمنة وغيرها من البينيات إلى أزمة الهوية والعزلة الاجتماعية التي يعتبرنها نمط حياة، خوفًا من مواجهة الآخر المتمثل في الأشخاص المعياريين/ات.
يعيش العديد منهن/م بأسماء مستعارة ويستأجرن/ون منازلهن/م عبر وسطاء/وسيطات، خوفًا من معرفة صاحب/ة المنزل لهويتهن/م الحقيقية. وهو ما قد يترتب عليه طردهن/م أو رفض طلب الاستئجار. هن/م محرومات/ون من كل الخدمات العمومية وخصوصًا الصحية، هروبًا من الوصم ونظرات الاحتقار والتساؤل والتمييز.
هذا بجانب الملاحقات الأمنية التي تهدد استقرارهن/م، إن تمت معرفة هوياتهن/م الحقيقية. وهو ما يدفع بالعديد منهن/م إلى عدم اللجوء إلى العدالة والمطالبة بتغيير الاسم، حسب المحامية والحقوقية هالة بن سالم. يرجع ذلك إلى الخوف من المسار القضائي المعقد الذي يمكن أن يلاحقهن/م بتهم على غرار “المساحقة أو اللواط”، استنادًا إلى الفصل 230 من المجلة الجزائية. تنص مقتضيات الفصل على أن “اللواط أو المساحقة، إذا لم يكن داخلًا في أي صورة من الصور المقررة بالفصول المتقدمة، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام”.
المعالجة الفنية لقضية البينية الجنسية في تونس… إنصاف أم إجحاف؟
شهدت السنة الفارطة طرحًا للبينية الجنسية في تونس من خلال فيلمين. وإن كانت هذه الطفرة الحقوقية من شأنها تغيير النظرة المحافظة للأشخاص اللامعياريات/ين، إلا أنها خلقت جدلًا في الأوساط الحقوقية ذاتها حول مدى استجابة الفيلمين إلى مشاكل وعوائق وضعية البينيات/ين الجنسيات/ين.
تفيد آمنة العرفاوي، الشخصية التي اقتبس من قصتها فيلم “الما-بين” للمخرجة ندى المازني، بأن الفيلم استجاب لمشاكل البينيات/ين وكان وفيًا لقصتها. في حين أنها وجدت بعض المغالطات في الفيلم الآخر المعروض في نفس التوقيت.
اختار فيلم “الإبرة”، لعبد الحميد بوشناق، طرح القضية من زاوية أخرى. وهي الزاوية العائلية داخل المجتمع الذكوري المحافظ والإقصائي. يعيش البطل داخل حي شعبي يمقت الاختلاف ويُجرّم المثلية الجنسية. فيفاجئ باستقباله لمولود/ة بيني/ة جنسيًا، ويستلزم عليه اختيار الجنس في غضون ثلاثة أيام.
لم يعالج الفيلم قضية البينية الجنسية والوضعية الاجتماعية للبينيات/ين، بقدر ما عالج الحاضنة الثقافية للعائلة المحافظة التي استقبلت المولود/ة. ورغم أن دور الأم منصفًا للمولود، إلا أن الفيلم ركّز بشكلٍ كبيرٍ على ردّات فعل الأب وطريقة تعامله الذكورية مع كل المحيطات/ين به، سواء داخل المنزل أو خارجه. خلق الفيلم تعاطفًا مع الذكورية الموغلة فيه، رغم أهمية طرحه لموضوع يُصنَّف من المُحرّمات في المجتمع التونسي.
تبقى الأعمال الدرامية والفنية المتعلقة بمجتمع الميم عين ضئيلة جدًا، مقارنةً ببقية الإنتاجات. وتكاد تُمنع المسرحيات التي تتضمن ألفاظًا تمسُّ “الأخلاق الحميدة” من العرض في المهرجانات المنظمة وطنيًا، مثل مسرحية “آخر البحر” للفاضل الجعايبي، والتي مُنعَت من العرض في مهرجان حمامات الدولي.
في الختام، تبقى آمنة وغيره/ها من الأشخاص البينيات والبينيين اللواتي/الذين اختارن/وا مشاركة قصصهن/م مع منصة “شريكة ولكن” يحملن/ون أملًا في تغيير حالاتهن/م الاجتماعية، وإصدار نص قانوني يُنصف حقوقهن/م ويُحد من أوجاعهن/م.
يناضلن/ون من أجل الأمل، ليتمكنّ/وا من ممارسة الحق في العيش بكرامة، والحق في النفاذ إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والصحية، دون وصمٍ أو تمييز أو احتقار أو اعتداء. هو حق من أجل الحياة.
كتابة: يسرى بلالي
